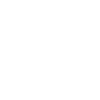الحلقة التاسعة

مفاهيم حول فلسفة القانون
يُعدّ القانون إحدى أهم الظواهر الاجتماعية التي عني الفكر الإنساني بتحليلها وفهمها عبر العصور. وفي هذا السياق، تبرز فلسفة القانون كفرع أساسي من فروع الفلسفة، يهدف إلى دراسة الطبيعة الجوهرية للقانون، وعلاقته بالقيم الإنسانية، والممارسات المجتمعية، والأنظمة السياسية. على عكس علم القانون (Jurisprudence) الذي يركز على استخلاص المبادئ العامة من الجزئيات والتطبيقات القانونية، فإن فلسفة القانون تتعمق في الافتراضات الكلية والمجردة التي قد تنطبق على جميع النظم القانونية الحالية، أو حتى على القوانين في جميع العصور.
إنها تسعى للإجابة عن أسئلة وجودية وفلسفية عميقة مثل: "ما هو القانون؟"، و"ما هي الضوابط التي تحكم صحة قرار قانوني ما؟"، و"ما العلاقة بين القانون والأخلاق؟".
ولعل الفهم الدقيق لهذه العلاقة هو ما يميّز الفلسفة القانونية. فكلمة "قانون" نفسها، المشتقة لغوياً من الأصل العربي "قانون"، تعني النظام أو المقياس. وهذا المفهوم اللغوي يحمل في طياته دلالة على أن القانون ليس مجرد أداة إجرائية، بل هو قيمة معيارية بطبيعته.
ينشأ هنا توتر فلسفي أساسي بين ما يمثله القانون كـ"مقياس" يجب أن يكون عادلاً ومثالياً، وبين ما هو عليه في الواقع كظاهرة اجتماعية تخضع للتطبيق والتجربة. هذا التباين هو جوهر الخلاف بين المذاهب القانونية الكبرى التي سنتعرض لها لاحقًا.
الجذور التاريخية لفلسفة القانون
لم ينشأ الفكر القانوني بمعزل عن التطور الفلسفي العام، بل كان جزءًا لا يتجزأ منه منذ أقدم العصور. يمكن تتبع جذوره الأولى إلى الفلاسفة اليونان، الذين لم يكتفوا بوصف القوانين القائمة، بل حاولوا الكشف عن طبيعتها وأسسها العميقة من خلال التأمل في مظاهر الحياة الاجتماعية.
لاحظ هؤلاء الفلاسفة النظام الثابت الذي يسير عليه الكون، وحاولوا تطبيق هذه الفكرة على النظام القانوني البشري، ليروا فيه تجسيدًا لقوانين طبيعية أسمى. كان للفلسفة الرواقية على وجه الخصوص إسهام كبير في هذا الصدد، حيث كانت أساس التشريع الروماني المعروف باسم "قانون الشعوب" (Jus Gentium)، ونشرت فكرة جوهرية وهي المساواة بين جميع الناس.
انتقلت هذه الفكرة لاحقاً إلى الرومان على يد فلاسفة مثل شيشرون، الذي عرّف القانون الطبيعي بأنه "مجموعة القواعد السرمدية التي لا تتغير، وتهدف للارتقاء بالقانون الوضعي باعتبارها المثل الأعلى المشترك بين جميع البشر".
يُظهر هذا المسار التاريخي تحولاً جذرياً في فهم مصدر السلطة القانونية. ففي البداية، كانت السلطة مستمدة من نظام كوني أو طبيعي أسمى (عند اليونان)، ثم اتخذت صبغة دينية في العصور الوسطى على يد فلاسفة الكنيسة مثل القديس أوغسطينوس وتوماس الأكويني، حيث أصبح القانون الطبيعي قانوناً إلهياً يسمو على القانون الوضعي.
ومع بزوغ فجر العصر الحديث، تحول مصدر السلطة القانونية ليصبح سياسياً وإنسانياً بحتاً، مع ظهور فكرة سيادة القانون في مواجهة سلطة الحاكم المطلقة. هذا التطور يعكس تحولاً في الوعي الإنساني من كونه خاضعاً لنظام كوني أو إلهي، إلى كونه صانعاً لنظامه القانوني الخاص، مما مهد الطريق لظهور المذاهب الوضعية التي سنتناولها بالتفصيل.
ماهية القانون: المفهوم، القاعدة، والمقاصد
قبل الخوض في المذاهب الفلسفية، من الضروري تحديد المفهوم الأساسي للقانون، وخصائص القاعدة التي يتكون منها، والأهداف التي يسعى لتحقيقها.
المفهوم الجوهري للقانون
القانون في جوهره هو نظام يحكم العلاقات بين الأفراد والمجتمع، ويضمن أسس التنظيم والعدالة.لا يقتصر دوره على مجرد وضع قواعد صارمة، بل يعمل كأداة فعالة لحماية الحقوق وتنظيم الواجبات، ويُعد لبنة أساسية في أي دولة تسعى لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تُعرّف القاعدة القانونية في أبسط صورها بأنها "مجموعة من القواعد التي تفرضها الدولة لضمان الانضباط داخل المجتمع وفرض النظام".كما يُنظر إلى القانون على أنه "قاعدة اجتماعية ضرورية" لاستمرار حياة البشر مع بعضهم البعض، فهو الذي يحدد الحقوق والواجبات.
يُعد القانون أداة ديناميكية لا تقتصر وظيفتها على مجرد الحفاظ على الوضع الراهن، بل تتجاوز ذلك لتساهم في "استشراف المستقبل والتخطيط له تحت مظلة العدل والأمان".
هذا يضع القانون في مركز العملية الاجتماعية كأداة للتغيير والتطور، وليس مجرد انعكاس جامد للواقع. هذا الفهم للقانون كأداة للتغيير هو ما يميز المدارس الاجتماعية والواقعية، ويُظهر أن القانون ليس مجرد كيان نظري، بل هو ظاهرة عملية تسعى لتحقيق غايات مجتمعية محددة.
خصائص القاعدة القانونية
تتميز القاعدة القانونية بخصائص جوهرية تميزها عن القواعد الاجتماعية أو الأخلاقية:
العمومية والتجريد: القاعدة القانونية موجهة إلى الأفراد بصفاتهم لا بذواتهم، فهي تخاطب المراكز القانونية وتطبق على جميع من تتوفر فيهم الشروط المذكورة في النص. هذه الخاصية تضمن مبدأ المساواة أمام القانون.
تنظيم السلوك الاجتماعي: القانون لا يهتم بالنوايا أو المشاعر الداخلية للأفراد، بل يركز على تنظيم سلوكهم الخارجي الظاهر في المجتمع.
الإلزام والجزاء: القاعدة القانونية ليست مجرد نصيحة، بل هي قاعدة ملزمة مرتبطة بجزاء مادي دنيوي يُوقعه القاضي أو السلطة العامة على من يخالفها، مما يضمن احترامها. إن فكرة الجزاء نفسها تحمل دلالة فلسفية عميقة. فبينما يرى البعض الجزاء مجرد عقوبة، فإن المذاهب الفلسفية تختلف حول دوره الجوهري. ففي مذهب أوستن، يُعد الجزاء هو العنصر الذي يمنح القاعدة القانونية قوتها الإلزامية، فبدونه لا يمكن أن يكون هناك قانون حقيقي.
في المقابل، ترى المذاهب المثالية أن الجزاء هو مجرد أداة لتطبيق قاعدة عادلة في جوهرها، وأن شرعية القاعدة لا تستمد من الجزاء، بل من مطابقتها لمثل أعلى أو لقانون طبيعي. هذا الاختلاف في فهم طبيعة الجزاء يوضح كيف أن كل مذهب ينظر إلى القانون من زاوية مختلفة، فبينما يراه البعض كأمر مدعوم بالقوة، يراه آخرون كقيمة يجب أن تُفرض بالقوة.
مقاصد القانون الأساسية: العدالة، الأمن، والنظام
يتفق غالبية الفقهاء والفلاسفة على أن غاية القانون النهائية هي تحقيق العدل، لكنهم يختلفون اختلافًا كبيرًا حول مفهوم العدل وكيفية تحقيقه.
يُعد تحقيق العدالة هو "الغاية الأساسية" للقانون، فالقاعدة القانونية غير العادلة لا تصلح أن تكون قاعدة قانونية. يشير التمييز بين مفهومي "العدل" و"العدالة" إلى جوهر الخلاف الفلسفي. فالعدل يعني المساواة بين الناس في تطبيق القواعد.
أما "العدالة" فهي مفهوم أعمق وأكثر مرونة، يُعنى بـ "مبادئ الإنصاف التي يمليها الضمير"، وهي تشكل المثل العليا والقيم التي تسعى القوانين لتحقيقها. وقد لاحظ أرسطو أن الجميع يتفق على أن العدالة في التوزيع يجب أن تكون وفقًا للاستحقاق، لكنهم يختلفون في فهم المقصود من هذا الاستحقاق. هذا الاختلاف في فهم "العدالة" هو ما يميز المذاهب الفلسفية عن بعضها البعض. فبينما يرى القانون الطبيعي أن العدالة مفهوم مطلق لا يتغير بتغير الزمان والمكان، وأنها قيمة عليا تشمل جميع القيم، يرى المذهب الوضعي أن القانون هو مرجع العدالة الوحيد، وأن القانون العادل هو ما يضعه المشرع.
أما المدارس الاجتماعية، فترى أن العدالة ليست ثابتة، بل هي "خاضعة للتغيير مع تطور المجتمعات"، وأنها تتحقق من خلال تلبية حاجات المجتمع وتطوره المستمر. هذا التباين في المفهوم يُظهر أن القانون ليس مجرد أداة لتحقيق هدف واحد، بل هو ساحة لتصادم وتفاعل تعريفات مختلفة للعدالة.
يتبع .....
أ.د إبراهيم احمد محمد الصادق