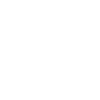الحلقة الثامنة

القانون الدولي، جدلية الحق والقوة وسؤال ما بعد القانون الدولي
مدخل
منذ نشأة المجتمعات الإنسانية الأولى، كان تنظيم العلاقات بين الجماعات والدول ضرورة وجودية لتفادي الفوضى والاقتتال.
إلا أن هذا التنظيم لم يأخذ شكله المؤسسي العالمي إلا بعد الحروب الكبرى التي هزّت العالم، لا سيما الحربان العالميتان الأولى والثانية. فقد أفرزت المآسي الجماعية نزعة إنسانية "عاطفية" دفعت باتجاه تقنين العلاقات الدولية ضمن منظومة قانونية عابرة للحدود.
وقد تجسد هذا التوجه في تأسيس منظمة الأمم المتحدة عام 1945، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، كنصوص تحمل وعودًا بمستقبل أفضل قوامه العدالة والمساواة.
لكن هذه النصوص لم تبقَ محايدة، إذ سرعان ما دخلت دائرة التوظيف السياسي. وبينما مثّلت القوانين الدولية خطابًا مثاليًا موجّهًا للبشرية جمعاء، فإن القوى الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين، استعملتها كأداة لتحقيق مصالحها وشرعنة هيمنتها.
هنا يبرز سؤال جوهري: هل وُجد القانون الدولي ليكون أداة لتحقيق العدالة بين الدول، أم أداة لإدامة هيمنة الأقوياء؟ ومن هذا السؤال تتولد إشكالية أعمق هي: ما بعد القانون الدولي، أي البحث عن بدائل جديدة للشرعية العالمية في حال انهيار المنظومة الراهنة.
المحور الأول: الخلفية التاريخية والفكرية
1. جذور القانون الدولي
يمكن ردّ جذور القانون الدولي الحديث إلى معاهدات وستفاليا عام 1648 التي أرست مبدأ سيادة الدولة الحديثة. هذا المبدأ كان نقلة نوعية في العلاقات الدولية، إذ انتقل العالم من الشرعية الدينية (البابوية والإمبراطورية) إلى شرعية سياسية تقوم على الدولة القومية.
ومع مرور الزمن، ظهرت قواعد العرف الدولي، ثم اتفاقيات لاهاي وجنيف التي سعت إلى تقنين قواعد الحرب وحماية المدنيين. وصولًا إلى تأسيس عصبة الأمم عام 1919 كأول محاولة مؤسساتية لتأمين السلم العالمي، ثم الأمم المتحدة التي ورثتها بعد الحرب العالمية الثانية.
2. البعد العاطفي في الخطاب الدولي
يحمل القانون الدولي في نصوصه طابعًا مثاليًا عاطفيًا، حيث يرفع شعارات مثل المساواة بين الدول، وعدم التدخل، واحترام حقوق الإنسان.
غير أن هذا الطابع، رغم جاذبيته، أخفى هشاشة بنيوية، لأنه لم يُبنَ على قوة متوازنة بل على توازنات قوى غير مستقرة. وهنا يكمن مصدر الجدل الذي سيلازم القانون الدولي: التوتر الدائم بين الحق كمبدأ والقوة كواقع
المحور الثاني: جدلية الحق والقوة
1. القانون الدولي بين النظرية والواقع
يُعرّف الفقيه النمساوي هانز كيلسن القانون بأنه نظام معياري مستقل عن السياسة والأخلاق، وركّز في "النظرية الخالصة للقانون" على ضرورة الفصل بين ما هو كائن (الواقع) وما يجب أن يكون (المعيار القانوني).غير أن الممارسة الدولية تناقضت مع هذا التصور، إذ ظل القانون الدولي محكومًا بإرادة الدول القوية لا بالمعايير المجردة.
أما الفقيه الإيطالي أنطونيو كاسيسي..، فقد ركّز على العدالة الدولية وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن القانون الدولي يجب أن يتطور باستمرار لحماية الأفراد من انتهاكات الدول.
لكن التطبيق الانتقائي لحقوق الإنسان كشف أن العدالة الدولية خضعت لهيمنة سياسية واضحة.
2. ازدواجية المعايير: الحالة الإسرائيلية نموذجًا
تُعد المواقف الأمريكية والأوروبية من الانتهاكات الإسرائيلية أبرز مثال على الانتقائية في توظيف القانون الدولي. فقد صدرت عشرات القرارات عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، لكن غالبيتها بقيت دون تنفيذ بسبب الدعم الغربي لإسرائيل.
هذه الازدواجية أضعفت مصداقية القانون الدولي وأظهرته أداة مسيّسة أكثر منه إطارًا حياديًا.
3. القانون الدولي كأداة هيمنة،السودان نموذجا
يمكن القول إن القانون الدولي، في صورته الراهنة، يخدم وظيفة مزدوجة: خطاب مثالي يخاطب الشعوب الضعيفة، وأداة عملية لتكريس مصالح الأقوياء.
هذه الجدلية بين الحق والقوة تجعل من القانون الدولي نظامًا غير مكتمل، يعيش دائمًا تحت رحمة موازين القوى السياسية والعسكرية.
وان سبق المثال باسرائيل، فإن الصورة المقابلة للقهر تتجلى في الحالة السودانية، حيث اصبح في مخيلة امريكا واروبا وطن يعاني من عدم الأهلية، متاح ومباح لكافة انواع التدخلات والوان الحصار لاقيمة لانسانه ولاتعريف لسيادته ولاحرمة لكيانه، يتجرأ عليه الاصاغر والآكابر، لايعصمه قانون دولي ولاتحميه شرعية دولية صورة مثالية للوطن المقهور
المحور الثالث: سؤال ما بعد القانون الدولي
1. ابن خلدون ونفسية المغلوب
يذهب ابن خلدون إلى أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، مما يكرّس تبعية ثقافية ونفسية تتجاوز الهزيمة العسكرية. وفي السياق الدولي، فإن الدول الضعيفة التي تلتزم بالقانون الدولي على نحو أعمى، رغم انحيازه، إنما تجسد هذه "النفسية المقهورة"
. 2 مالك بن نبي والقابلية للاستعمار
توسّع مالك بن نبي في هذه الفكرة عبر نظريته عن "القابلية للاستعمار"، حيث لا يكفي أن يكون هناك غزو خارجي، بل يحتاج إلى بيئة داخلية قابلة للخضوع. وهذا ينطبق على القانون الدولي: فقبول الدول الضعيفة بالمنظومة رغم اختلالها يعكس حالة من الاستسلام الفكري والسياسي.
3 مآلات النظام الدولي
حين يصبح القانون الدولي أداة لشرعنة الهيمنة بدلًا من مقاومتها، فإن ذلك يطرح سؤال "ما بعد القانون الدولي". وقد ظهرت بالفعل مؤشرات لذلك:
* صعود قوى جديدة مثل الصين وروسيا تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة. * بروز أطر إقليمية (الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، منظمة شنغهاي) تحاول صياغة بدائل جزئية.
* تراجع ثقة الشعوب الضعيفة في شرعية القانون الدولي. قد لا يعني "ما بعد القانون الدولي" انهيارًا كاملاً للمنظومة، لكنه يعني بالتأكيد أن العالم يتجه إلى مرحلة جديدة تعاد فيها صياغة مفهوم الشرعية والعدالة على أسس مختلفة.
الخلاصة
يمكن القول إن القانون الدولي وُلد من رحم الحروب ليكون إطارًا يحمي البشرية من ويلات النزاعات، لكنه سرعان ما تحول إلى منظومة مشوبة بالانتقائية والتوظيف السياسي. جدلية الحق والقوة التي تهيمن عليه تكشف أن القانون الدولي لم يكن يومًا بريئًا أو محايدًا، بل ظل أسيرًا لموازين القوى.
ومع ذلك، فإن ضعف الضعيف، كما أشار ابن خلدون، ليس صيرورة أبدية، بل قد يفضي إلى ثورات فكرية وسياسية تطرح بديلاً جديدًا. وما طرحه مالك بن نبي من فكرة "القابلية للاستعمار" يوضح أن تجاوز هذه الحالة يحتاج إلى وعي وإرادة داخلية قبل البحث عن نظام دولي عادل.
إن سؤال "ما بعد القانون الدولي" ليس ترفًا فكريًا، بل هو ضرورة لفهم التحولات الجارية. فإما أن يُعاد بناء القانون الدولي على أسس أكثر عدلاً وتوازنًا، وإما أن ينهار لصالح أنماط جديدة من الشرعية قد تكون أكثر خطورة.
أ.د ابراهيم احمد محمد الصادق