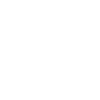الحلقة العاشرة

التجزئة التصورية واثرها على الهوية المعرفية بالتطبيق على الدراسات القانونية
ولعلنا نسأل ابتداءً ما المقصود بالتجزئة التصورية ؟
من ناحية إجرائية نقصد بها ذلك الانفصام بين دائرتي العلم والعمل، واليك هذه المقاربة لما ذكره اهل العلم في التعريف المعهود وهم يتناولون قضايا المعرفة....وذلك في قولهم:
فالعلم هو الصورة الحاصلة من الشيء في القوة العاقلة المسماة بالذهن، وهو نوعان:
العلم الحضوري، والعلم الحصولي؛ وذلك لأن الإدراك تميُّز وحضور وظهور للشيء عند العقل، فإن كان تميزه وحضوره وظهوره عند العقل بحقيقته المتحققة في الخارج، يسمى: علمًا حضوريًّا،
وإن كان تميزه وحضوره وظهوره عند العقل بصورته الحاصلة له في العقل المنتزعة منه المساوية له، يسمى: علمًا حصوليًّا،
وينقسم العلم أيضًا إلى قسمين:
الأول: التصور، والثاني: التصديق. وذلك لأن تلك الصورة إن كانت خالية عن الحكم، تسمى تصورًا، وإن كانت مع الحكم تسمى تصديقًا.
غير اننا هنا نستعين بما اختاره مؤلف كتاب خصائص التصور الإسلامي بقوله(أهمية إدراك خصائص التصور الإسلامي ومقوماته في حمل الإنسان على إيجاد تفسير شامل للوجود يترتب عليه معرفة حقيقة مركزه في هذا الوجود الكوني وغاية وجوده الإنساني؛ فيتعرف على دوره في الكون وحدود اختصاصاته وحدود علاقته بخالقه خالق هذا الكون،
ونتيجة لهذه المعرفة يحدد منهج حياته ونوع النظام الذي يحقق هذا المنهج والذي ينبثق عن التفسير الشامل الذي أدركه. وما التخبط والصدام والشقاء ومخالفة الفطرة التي نراها في أيامنا هذه إلا نتيجة لإخفاق الإنسان في إيجاد هذا النظام واستبداله بأنظمة مفتعلة مصطنعة لا تقدر على البقاء لعدم امتلاكها لمقومات البقاء. فهذا الدين والتصور المبني عليه جاء لينشئ أمة ذات طابع متميز ومتفرد لتقود البشرية وتحقق منهج الله في الأرض وتنقذ البشرية من القيادات الضالة والمناهج الضالة.
وإدراك الفرد المسلم لطبيعة هذا التصور الإسلامي تؤهله ليكون عنصراً صالحاً في بناء هذه الأمة).
أقول أن المشكلة الحضارية الكبرى التي ظلت تعاني منها الأمة بسبب دخولها مرحلة العطالة الفكرية، وهي المرحلة التي عطلت فيها العقل وفعالية العقل لتصبح تابعا ذلك، ان الانفصام بين العقول النابهة التي حافظت على تقدم النشاط العقلي وقيادته وسيادته ظهر في المقارنة بين ما أنتجه العقل المسلم من لدن الائمه الكبار، أبو حنيفة، مالك ،الشافعي احمد ،وأيضا الغزالي ابن تيمية ابن خلدون ابن رشد الشاطبي .
ثم بداية الانكفاء والضمور ومحاولة إعادة ما سبق برؤية قاصرة وجعل ذلك غاية التفكير والإبداع والنوم في ظلال ما أنتجه العقل في فترة بعينها ومن ثم تسليم القياد للعقل الغربي بحكم فعاليته ليملا الفراغات العلمية فكر وإنتاجا، ويهيمن على الحياة.
بينما ظلت الدراسات المعتمدة على البحث العلمي والتنقيب والاستكشاف والاستقصاء والمقارنة في واقعنا دراسات منفصمه عن الواقع بصورة مزعجة، ، واعتمدت على إجراءات شكلية لا تتجاوز الأطر الوظيفية والمجادلات الشكلية، ، هذا الانفصام كرسته تلك الهزيمة الحضارية فأصبحت المناهج التعليمية غير موصولة بالأطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية،
وادى هذا بالضرورة إلى ضعف الاهتمام من قبل الأستاذ والطالب كنموذج اولي والكل يراقب ذلك الانفصام بين قاعة الدرس (وقيعان) العمل، وضاعت الفكرة القائدة والمفكر القائد ، ومن اهم تجليات ذلك الانفصام :
تعدد الجماعات بديلا للأمة
الأحزاب الايدلوجية بديلا للمذاهب الفقهية
المناهج الهجين بديلا للرؤى المقاصدية
إعادة التاريخ بديلا للإبداع والابتكار
تلقينيه العطاء والتلقي بديلا للنظر والاجتهاد
غثائية المنتج بديلا للإصالة،
تبعية الغرب وحالة القابلية للاستعمار بديلا للشهادة والشهود
غير ان مقصدنا في هذه الدراسة هو القانون، واشكالية القانون المقارن واضطراب العلاقة بين الفقه والقانون جراء خلاسية المنهج وتمدد الفكرة الهجين في فراغ الاضطراب المنهجي
وهنا وحتى اختم بالإيجابية لابد من القول، ان علم أصول الفقه متضمنا المقاصد، يمثل العاصم الأول للعقل المسلم بل هو الابداع الموروث للعقل المسلم في اعظم فتراته وابداعاته، ،
،فكيف السبيل لتحرير علم الأصول من دائرة التلقي الاكاديمي ليصبح هو العلم الذي يسير الحياة بكل ضروبها ومسالكها كما عبر عن ذلك علماء الأصول .
وهذا مدخلنا للحديث عن التجزئة التصورية واثرها على الهوية المعرفية بالتطبيق على الدراسات القانونية
...يتبع
أ.د إبراهيم أحمد محمد الصادق